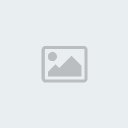
تفسير سورة الحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.
فإننا نبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدىء من سورة (ق) عند بعض العلماء، أو من سورة الحجرات عند آخرين.
وسنتكلم على سورة الحجرات لما فيها من الآداب العظيمة النافعة التي ابتدأها الله بقوله تبارك وتعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم }. اعلم أن الله تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم } فإنه كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إما خير تُؤمر به، وإما شر تنهى عنه، فأرعه سمعك، واستمع إليه لما فيه من الخير، وإذا صدَّر الله الخطاب بـ{يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم } دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، يقول الله عز وجل: {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم } قيل: معنى {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم } أي: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، والمراد: لا تسبقوا الله ورسوله بقولٍ أو بفعل. وقيل: المعنى لا تقدموا شيئاً بين يدي الله ورسوله. وكلاهما يصبان في مصب واحد، والمعنى: لا تسبقوا الله ورسوله بقولٍ ولا فعلٍ، وقد وقع لذلك أمثلة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » () لأن الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله، فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته، ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » () . ومن التقدُّم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعها،فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل هي أشد التقدم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور ». وأخبر بأن « كل بدعة ضلالة » () . وصدق - عليه الصلاة والسلام - فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات، مما يدعي أنه شرع، كأنه يقول: إن الشريعة لم تكمل، وأنه كملها بما أتى به من البدعة، وهذا معارض تماماً لقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم }. فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كمال في الدين؟ إن قال: نعم، فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم }، وإن قال: ليس كمالاً في الدين، قلنا: إذن هو نقص؛ لأن الله يقول: { فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون } فالبدعة كما أنها ضلالة في نفسها فهي في الحقيقة تتضمن الطعن في دين الله، وأنه ناقص، وأن هذا المبتدع كمله بما ادعى أنه من شريعة الله - عز وجل - فالمبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يبالوا بهذا النهي حتى وإن حسن قصدهم؛ فإن فعلهم ضلالة، وقد يُثاب على حسن قصده، ولكنه يؤزر على سوء فعله، ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها، ويرجع إلى الله - عز وجل - ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والبدعة أنواع كثيرة: بدع في العقيدة، وبدع في الأقوال، وبدع في الأفعال.
أما البدع في العقيدة ، فإنها تدور على شيئين:
إما تمثيل، وإما تعطيل. فالتمثيل أن يثبت لله تعالى الصفات، لكن على وجه المماثلة، فإن هذا بدعة؛ لأنه لم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائهالراشدين، فيكون بدعة، فمثلاً يثبت أن لله وجهاً ويجعله مماثلاً لأوجه المخلوقين، أو أن لله يداً ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين، وهلم جرا، فهؤلاء مبتدعة بلا شك، وبدعتهم تكذيب لقوله تعالى: {ليس كمثله شيء } ولقوله: {ولم يكن له كفواً أحد }. ولقوله تعالى: {هل تعلم له سمياً } .
أما التعطيل فهو أن ينكر ما وصف الله تعالى به نفسه، فإن كان إنكار جحد وتكذيب، فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهو تحريف وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله، فإن كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب، فمثلاً إذا قال إنسان: إن الله سبحانه وتعالى قال: {بل يداه مبسوطتان } والمراد باليدين النعمة نعمة الدين ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، فهذا تحريف؛ لأن النعمة ليست واحدة، ولا ألف ولا ملايين، {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } فليست النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع، فيكون هذا تحريفاً وبدعة، لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، والأئمة الهداة من بعدهم.
أما البدعة في الأقوال : فمثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات، لم ترد بها السنة، أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة، وليست من الأدعية المباحة.
وأما بدع الأفعال : فمثل الذين يصفقون عند الذكر، أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة تعبداً، أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك الذين يتمسَّحون بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة قبره الشريف، وكذلك الذين يتمسَّحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك.
والبدع كثيرة: العقدية والقولية والفعلية، وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله، وكلها معصية لله ورسوله، فإن الله يقول: {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم }
والنبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: «إياكم ومحدثات الأمور» .
ومن البدع ما يُصنع في رجب، كصلاة الرغائب التي تُصلَّى ليلة أول جمعة من شهر رجب، وهي صلاة ألف ركعة يتعبدون لله بذلك، وهذا بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعداً؛ لأن كل من تقرَّب إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم، لا يقبل الله منه تعبده، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» () . ومن التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله أن يقول الإنسان قولاً يُحكم به بين عباد الله أو في عباد الله، وليس من شريعة الله، مثل أن يقول: هذا حرام، أو هذا حلال، أو هذا واجب، أو هذا مستحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله، وعلى من قال قولاً وتبين له أنه أخطأ فيه أن يرجع إلى الحق حتى لو شاع القول بين الناس وانتشر وعَمِلَ به مَن عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يُعلن رجوعه أيضاً، كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذوراً فيها إذا كانت صادرة عن اجتهاد ، فالواجب الرجوع إلى الحق، فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
{واتقوا الله} هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأن التقدم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، لكن نص عليه وقدمه لأهميته، ومعنى {واتقوا الله} أي اتخذوا وقاية من عذاب الله - عز وجل - وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر تقرُّباً إلى الله تعالى، ومحبة لثوابه، وترك النواهي خوفاً من عذاب الله - عز وجل - ، ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وتصاعد في نفسه وعز في نفسه، وأوغل في الإثم، وانتفخت أوداجه، وقال: أمثلي يُقال له: اتق الله! وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله لله، فأمره بالتقوى، قال الله تبارك وتعالى: {ياأيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً }. وقال الله تعالى: {واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه }. ومن الذي لا يستحق أن يُؤمر بتقوى الله؟ فكل واحد منَّا يستحق أن يؤمر بتقوى الله - عز وجل - والواجب أنه إذا قيل له: اتق الله. أن يزداد خوفاً من الله، وأن يراجع نفسه، وأن ينظر ماذا أمر به، إنه لم يؤمر أن يتقي فلاناً وفلاناً، إنما أمر أن يتقي الله عز وجل، وإذا فسرنا التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره، تقرباً إليه ومحبة لثوابه، وترك نواهيه خوفاً من عقابه، فإن أي إنسان يترك واجباً فإنه لم يتق الله، وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من المخالفة، فالتقوى مخالفتها تختلف، فقد تكون مخالفتها كفراًًً وقد تكون دون ذلك، فترك الصلاة مثلاً ترتفع به التقوى نهائياً؛ لأن تارك الصلاة كافر، كما دلَّ على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومنهم التابعي المشهور عبدالله بن شقيق - رحمه الله - حيث قال: ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ) () . وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه، ولم يصح عن أي صحابي أنه قال عن تارك الصلاة: إن تارك الصلاة في الجنة، أو إنه مؤمن، أو ما أشبه ذلك، والزاني لم يتق الله؛ لأنه زنا فخالف أمر الله وعصاه، والسارق لم يتق الله، وشارب الخمر لم يتق الله، والعاق لوالديه لم يتق الله، والقاطع لرحمه لم يتق الله، والأمثلة على هذا كثيرة، فقوله تعالى: { واتقوا الله } كلمة عامة شاملة تشمل كل الشريعة { إن الله سميع عليم } هذه الجملة تحذير لنا أن نقع فيما نهانا عنه من التقدُّم بين يدي الله ورسوله، أو أن نخالف ما أمر به من تقواه {سميع} أي سميع لما تقولون { عليم } أي عليم بما تقولون وما تفعلون؛ لأن العلم أشمل وأعم، إذ إن السمع يتعلق بالمسموعات، والعلم يتعلق بالمعلومات، والله تعالى محيط بكل شيء علماً، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول العلماء - رحمهم الله -: إن السمع الذي اتصف به ربنا - عز وجل - ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة، فسمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظهر، حتى إنه - عز وجل - يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: { قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركمآ إن الله سميع بصير }. قالت عائشة - رضي الله عنها -: ( الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة - أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم - والمرأة تجادله وهو يحاورها وإنه ليخفى عليَّ بعض حديثها ) () . والله - عز وجل - أخبر بأنه سمع كل ما جرى بين هذه المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سمع إدراك، ثم إن سمع الإدراك قد يُراد به بيان الإحاطة والشمول، وقد يراد به التهديد، وقد يُراد به التأييد، فهذه ثلاثة أنواع.
الأول: يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية.
الثاني: يُراد به التهديد مثل قوله تعالى: { لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأَنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق }. وانظر كيف قال: { سنكتب ما قالوا } حين وصفوا الله تعالى بالنقص ، قبل أن يقول : { وقتلهم الأَنبياء } مما يدلّ على أن وصف الله بالنقص أعظم من قتل الأنبياء.
الثالث: سمع يُراد به التأييد، ومنه قوله - تبارك وتعالى - لموسى وهارون : { لا تخافآ إننى معكمآ أسمع وأرى }، فالمراد بالسمع هنا التأييد يعني: أسمعك وأؤيدك ، يعني أسمع ما تقولان وما يُقال لكما.
أما سمع الإجابة فمعناه : أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم : { إن ربي لسميع الدعاء }. أي مجيب الدعاء، ومنه قولالمصلي: ( سمع الله لمن حمده ) يعني استجاب لمن حمده فأثابه، ولا أدري أنحن ندرك معنى ما نقوله في صلاتنا أو أننا نقوله تعبداً ولا ندري ما المعنى؟! عندما نقول: الله أكبر، تكبيرة الإحرام يعني أن الله أكبر من كل شيء - عز وجل - ولا نحيط بذلك ؛ لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا، وعندما نقول: سمع الله لمن حمده. يعني استجاب الله لمن حمده ، وليس المعنى أنه يسمعه فقط ، لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم ، لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب ، فهذا السمع يقتضي الاستجابة لمن دعاه .
أما قوله تعالى: {عليم } فالمراد أنه ذو علم واسع، قال الله تعالى: { لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما }. فعندما تؤمن بأن الله سميع ، وأن الله عليم ، هل يمكن وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضيه ؟ لا ، لأنه يسمع ، فلا ينبغي لك أن تُسمِع الله ما لا يرضاه منك ، أسمِعْهُ ما يحبه ويرضاه إذا كنت مؤمناً حقًّا بأن الله سميع، وأعتقد لو أن أباك نهاك عن قول من الأقوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نهاك عنه؟ فالله أعظم وأجلّ، فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك، وإذا آمنت بأنه بكل شيء عليم وهذا أعم من السمع؛ لأنه يشمل القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس به نفسك يعلمه - عز وجل - إذا علمت ذلك هل يمكن أن تفعل شيئاً لا يُرضيه؟ لا، لأنه ليس المقصود من إخبار الله لنا بأنه عليم بكل شيء، أن نعلم هذا وأن نعتقده فقط. بل المقصود هذا، والمقصود شيء آخر، وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على أنه بكل شيء عليم، فإذا علمنا بأنه بكل شيء عليم فهل نقول بما لا يرضى؟ لا، لأنه سوف يعلمه، وإذا علمنا بأنه على كل شيء عليم هل نعتقد ما لا يرضى؟ لا، لأننا نعلم أنه يعلم ما في قلوبنا، قال الله تعالى: { واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه }. وقال تعالى: { واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه }،يحول بينك وبين قلبك ، فيجب علينا إذا مر بنا اسم من أسماء الله تعالى ، أو صفة من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسم ، وهذه الصفة، وأن نقوم بما هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسم ، أو الصفة . وما تضمنته الآية الكريمة من أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه. وهذا هو الأدب الأول .
أما الأدب الثاني ففي قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون }، الآية الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء، سواء من الأقوال أو الأفعال أو غيرها، أما هذه الآية فهي في رفع الصوت وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب، يقول الله - عز وجل - : { لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي } فإذا خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم بصوت فاخفض صوتك عن صوته، وإذا رفع صوته فارفع صوتك لكن لابد أن يكون دون صوت الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولهذا قال: { لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي } .
{ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض } يعني لا تنادونه بصوت مرتفع، كما ينادي بعضكم بعضاً، بل يكون جهراً بأدب وتشريف وتعظيم، يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كقوله: { لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً }. يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض، إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا، بل يجب عليكم الإجابة، كما قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } وهنا قال: { ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بعضكم لبعض } كذلك أيضاً لا تنادونه بما تتنادون به، فلا تقولون: يا محمد، ولكن قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، وما أشبه ذلك. { أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون } يعني كراهة أن تحبط أعمالكم، والمعنى إنما نهيناكم عن رفع الصوت فوق صوته،وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجهر له بالقول كجهره لبعض الناس، قد يحبط عمله من حيث لا يشعر؛ لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردَّة عن الإسلام توجب حبوط العمل، ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه - جهوري الصوت، وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما نزلت هذه الآية تغيَّب في بيته وصار لا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت الآية، فأرسل إليه رسولاً يسأله، فقال: إن الله تعالى يقول: { يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون } .
وإنه قد حبط عمله، وإنه من أهل النار، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فحضر، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وقال: « أما ترضى أن تعيش حميداً، وتُقتل شهيداً، وتدخل الجنة؟ » () قال : بلى رضيت، فقُتل - رضي الله عنه - شهيداً في وقعة اليمامة، وعاش حميداً، وسيدخل الجنة بشهادة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولذلك كان ثابت - رضي الله عنه - ممن يُشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه؛ لأن كل إنسان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فهو في الجنة، وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار، وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فنشهد له بالعموم، فنقول: كل مؤمن في الجنة، وكل كافر في النار، ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار، أو من أهل الجنة إلا من شهد له الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهره لسائر الناس، وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولما نزلت هذه الآية تأدَّب الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك حتى كان بعضهم يكلمه مسارَّة ولا يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول من إسراره، حتى يستثبته مرة أخرى ، وفي هذه الآية دليل على أن كل من استهان بأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإن عمله حابط؛ لأن الاستهانة بالرسول - عليه الصلاة والسلام - ردَّة، والاستهزاء به ردَّة كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم : { ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب } وكانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه - أرغب بطوناً - يعني أوسع - ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكذب ألسناً، فأنزل الله هذه الآية، ولما سألهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتكلم بكلام لا نريده ، ولكن لنقطع به عنا عناء الطريق ، فأنزل الله هذه الآية. { قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم }. ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان كافراً مرتدًّا، فإن تاب قبلنا توبته لكننا لا نرفع عنه القتل، بل نقتله أخذاً بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي.
ثم أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: { إن الذين يغضون أصوتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم } لما نهى عن رفع الصوت فوق صوته، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يخفضونها ويتكلمون بأدب، فلا إزعاج ولا صخب، ولارفع صوت، لكن يتكلمون بأدب وغض، قال الله تعالى: { أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى } أعاد الإشارة { أولئك } تعظيماً لشأنهم ورفعة لمنزلتهم، لأن { أولئك } من أسماء الإشارة الدالة على البعد، وذلك لعلو منزلتهم ، فأتى باسم الإشارة بياناً لرفعة منزلتهم وعلوها.
{ امتحن الله قلوبهم }. قال العلماء: معناها أخلصها للتقوى، فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله - عز وجل - ولهذا تأدَّبوا بآداب الله تعالى التي وجه لها فغضوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن ثوابهم: { لهم مغفرة وأجر عظيم }، مغفرة من الله لذنوبهم، وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة، وفي هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب، لقوله: { امتحن الله قلوبهم للتقوى }. وكما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: « التقوى هاهنا » وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب ثلاث مرات: « التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا » () ولا شك أن التقوى تقوى القلب، أما تقوى الجوارح وهي إصلاح ظاهر العمل، فهذا يقع حتى من المنافقين: { وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم } لكن الكلام على تقوى القلب التي هي بها الصلاح ، نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. وبعض الناس يفعل المعاصي كإسبال الثوب مثلاً، أو حلق اللحية، أو شرب الدخان، وتنهاه وتخوِّفه من عقاب الله، فيقول: التقوى هاهنا، كأنه يزكي نفسه، وهو قائم بمعصية الله، فنقول له بكل سهولة: لو كان ما هنا متقياً لكانت الجوارح متقية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله » () .
{ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون }. هذه الآية تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان معهم قوم جُفاة لا يقدرون الأمور قدرها، فجعلوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته - أي حجرات نسائه - ويرفعون أصواتهم بذلك يريدون أن يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم () ، يقول الله في هؤلاء: { أكثرهم لا يعقلون } يعني ليس عندهم عقل، والمراد بالعقل هنا عقل الرشد؛ لأن العقل عقلان: عقل رشد، وعقل تكليف، فأما عقل الرشد فضده السفه، وأما عقل التكليف فضده الجنون، فمثلاً: إذا قلنا: يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضىء عاقلاً مميزاً، فالمراد بالعقل هنا عقل التكليف، وإذا قلنا: يشترط للتصرف في المال أن يكون المتصرف عاقلاً، أي عقل رشد، يحسن التصرف، فالمراد بقوله هنا: { أكثرهم لا يعقلون } أي عقل رشد؛ لأنهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذم، لأن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم، وهذا واضح، وقوله: { أكثرهم لا يعقلون } يفهم منه أن بعضهم يعقل وأنه لم يحصل منه رفع صوت، بل هو متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال تعالى: { ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم } أي لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم من بيتك، وتكلمهم بما يريدون لكان خيراً لهم في أنهم يلتزمون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاجتهم ستقضى؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأته أحد في حاجة إلا قضاها، إذا كان يدركها، وهو أحق الناس بقول الشاعر:
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم
{ والله غفور رحيم } في قوله: { والله غفور رحيم } إشارة إلى أن الله غفر لهم ورحمهم، وهذا من كرمه - جل وعلا - أنه يغفر ويرحم، وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر الشرك به، ويغفر ما دون ذلك، أي سوى الشرك لمن يشاء، فكل أحد أذنب ذنباً دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له ما لم يتب، فإذا تاب فلا عذاب، لقوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها ءاخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف لهالعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً }. وقلنا: إن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمهم؛ لأن الله ختم الآية بقوله: {والله غفور رحيم } وهذا يدل على أنه غفر لهم ورحمهم، ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً، قال: { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأَرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأَرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأَخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم }. أخذ العلماء من هذه الآية أن هؤلاء المفسدين المحاربين لله ورسوله، إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم العذاب، واستدلوا بأن الله ختم الآية بقوله: {فاعلموا أن الله غفور رحيم } أي قد غفر لهم فرحمهم، وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في الآيات، إن ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الآية، ولهذا قرأ رجل فقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم } فسمعه أعرابي عنده فقال له: أعد الآية، فأعادها وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم } قال له: أعد الآية، فأعادها فقال: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم } فقال: الآن أصبت، ثم علل فقال: لأنه لو غفر ورحم ما قطع، ولا تتناسب المغفرة والرحمة مع القطع، لكنه عز وحكم فقطع، فتأمل هذا الفهم فإنه مفيد جدًّا، والشاهد من هذا أن قوله تعالى: { ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم } يدل على أن الله غفر لهم ورحمهم.
ثم قال الله - تبارك وتعالى -: { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } تقدم الكلام على قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }: { إن جاءكم فاسق } الفاسق هو من انحرف في دينه وعقيدته ومروءته، وضده العدل وهو من استقام في دينه ومروءته، فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته بمعنى أنه مصر على المعاصي تارك للواجبات، لكنه لم يصل إلى حد الكفر، أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس مشية الهوجاء، ويتحدث برفع صوت، ويأتي معه بأغراض بيته، يطوف بها في الأسواق وما أشبه ذلك مما يخالف المروءة، فهذا عند العلماء ليس بعدل. { إن جاءكم فاسق بنبإ } أي جاءكم بخبر من الأخبار، وهو فاسق، مثال ذلك: جاءنا رجل حالق للحيته، وحالق اللحية فاسق، لأنه مصر على معصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « أعفوا اللحى » () . وهذا لم يعف لحيته، بل حلقها، فهذا الرجل من الفاسقين؛ لأنه مصر على معصية، جاءنا بخبر فلا نقبله لما عنده من الفسق، ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقاً، ولهذا قال الله - عز وجل -: { فتبينوا } ولم يقل فردوه، ولم يقل فاقبلوه، بل يجب علينا أن نتبين، وفي قراءة (فتثبتوا) وهما بمعنى متقارب، والمعنى: أن نتثبت.
فإذا قال قائل: إذن لا فائدة من خبره.
قلنا: لا بل في خبره فائدة، وهو أنه يحرك النفس حتى نسأل ونبحث؛ لأنه لولا خبره ما حركنا ساكناً، لكن لما جاء بالخبر نقول: لعله كان صادقاً، فنتحرك ونسأل ونبحث، فإن شهد له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الدالة على صدقه، وإلا رددناه، وقوله - سبحانه وتعالى -: { إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } يفيد أنه إن جاءنا عدل فإننا نقبل الخبر، لكن هذا فيه عند العلماء تفصيل، دل عليه القرآن والسنة، فمثلاً الشهادة بالزنا: لو جاءنا رجل عدل في دينه، مستقيم في مروءته، وشهد أن فلاناً زنا فلا نقبل شهادته، وإن كان عدلاً، بل نجلده ثمانين جلدة؛ لأنه قذف هذا الرجل البريء بالزنا، وقد قال الله تعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً }، فنجلده ثمانين جلدة ولا نقبل له شهادة أبداً، ونحكم بأنه فاسق، وإن كان عدلاً حتى يتوب، وإذا شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنا فلا نقبل شهادتهما، ولا ثلاثة، فإذا كانوا أربعة عدول فنعم؛ لأن الله تعالى قال: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون }. وقال تعالى: { لولا جاءو عليه بأربعة شهداء } {فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } حتى وإن كانوا صادقين، فلو جاءنا ثلاثة نعرف أنهم ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون غير مقبولين، نجلد كل واحد ثمانين جلدة، وإذا جاءنا رجل شهد على شخص بأنه سرق فلا نقبل شهادته، بل لابد من رجلين، وإذا جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان فنقبل شهادته، لأن السنة وردت بذلك، فقد قال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: تراءى الناس الهلال - يعني ليلة الثلاثين من شعبان - فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بالصيام () ، وإذا كان رجل غنيًّا ثم أصيب بجائحة ثم جاء يسأل الزكاة، وأتى بشاهد أنه كان غنيًّا وأصابته جائحة وافتقر فلا نقبل شهادة الواحد، ولا نقبل شهادة اثنين، بل لابد من ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة: « إنها لا تحل المسألة » وذكر منها رجل أصابته جائحة - يعني اجتاحت ماله - فشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: إن فلاناً قد أصابته جائحة فحلت له المسألة () (ثلاثة من ذوي الحجا) يعني من ذوي العقل، وكذلك نقبل رجلاً مع يمين المدعي كما لو ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه ألف ريال، فقلنا للمدعي: هات بينة، قال: عندي رجل واحد، فإذا أتى برجل واحد وحلف معه، حكمنا له بما ادعاه وهناك أشياء أيضاً لا يتسع المجال لذكرها، وعلى هذا فخبر العدل فيه تفصيل على ما تقدم وخبر الفاسق يتوقف فيه حتى يتبين الأمر، ثم بين الله - عز وجل - الحكمة من كوننا نتبين بخبر الفاسق فقال: { أن تصيببوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } يعني أمرناكم أن تتثبتوا كراهة أن تصيبوا قوماً بجهالة؛ لأن الإنسان إذا تسرع ولم يتثبت فقد يعتدي على غيره بناءً على الخبر الذي سمعه من الفاسق، وقد يكرهه، وقد يتحدث فيه في المجالس، فيصبح بعد أن يتبين أن خبر الفاسق كذب نادماً على ما جرى منه، وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل من الأخبار ولا سيما مع الهوى والتعصب، فإذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم تثق بقول المخبر فيجب أن تتثبت، وألا تتسرع في الحكم؛ لأنك ربما تتسرع وتبني على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد، ومن ثم جاء التحذير من النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يدخل الجنة قتَّات» () أي نمَّام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يُعذبان، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير» - أي في أمر شاق عليهما - «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول»، أو لا يستبرىء أو لا يستنزه من البول «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» يمشي بين الناس ينمّ الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس، ثم أخذ جريدة رطبة فشقَّها نصفين وغرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله، لمَ فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» () . ومن هذا النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوى التي لم يتكلم بها إطلاقاً، أو تكلم ولكن فُهِمَ ما ينقل عنه خطأ، فإن بعض الناس قد يفهم من العالِم كلمة على غير مراد العالِم بها، وقد يسأل العالِم سؤالاً يتصوره العالم على غير ما في نفس هذا السائل، ثم يجيب على حسب ما فهمه، ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحيح، وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلاء، لم يكن لها أصل؛ لهذا يجب التثبُّت فيما يُنقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء، وكثر فيه التعصب، وصار الناس كأنهم يمشون في عمى.
قول الله - تبارك وتعالى -: {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأَمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإِيمان وزينه في قلوبكم } هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله } وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيهم، فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تُعرف عدالته، وكأن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه () ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } ولكن العبرة بعموم اللفظ وقوله: {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأَمر لعنتم } أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا له أمثلة كثيرة منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام فانصرفوا وقد بقي من الليل ما بقي، وقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا - يعني طلبوا منه أن يقوم بهم كل الليل - ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة» () ولم يوافقهم على طلبهم، لما في ذلك من العنت والمشقة، ومنها أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن أمره في السر - يعني فيما لا يظهر للناس - وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات فكأنهم تقالُّوها فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما هم فلم يكن لهم ذلك، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أناأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أما أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» () فحذرهم أن يعملوا عملاً يشق عليهم، ومن ذلك أيضاً حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه وعن أبيه - أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنه ليصومن النهار، وليقومن الليل ما عاش، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنت قلت هذا؟» قال: نعم، قال: «إنك لا تطيق ذلك» () ثم أرشده لما هو أفضل وأهون، والحاصل أنه يوجد من الصحابة - رضي الله عنهم - من له همَّة عالية لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يطيعهم في كثير من الأمر؛ لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم، ثم قال عز وجل: {ولكن الله حبب إليكم الإِيمان }، قد يقول قائل: ما هو ارتباط قوله: {ولكن الله حبب إليكم الإِيمان } بقوله: {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأَمر لعنتم }؟.
والجواب: أنكم تطيعونه - أي الرسول عليه الصلاة والسلام - فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبَّب إليكم الإيمان فتقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبَّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعني: ولكن إذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك، ولن تخالفوه، ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه، {ولكن الله حبب إليكم الإِيمان } - أي جعله محبوباً في قلوبكم - {وزينه في قلوبكم } بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به - وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة، لكن إذا زُيّن له الشيء ثبت في المحبة ودامت، ولهذا قال: {حبب إليكم الإِيمان } وهذا في القلب، {وزينه في قلوبكم } أيضاً في القلب، لكن إذا زين الشيء المحبوب للإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان } كرّه إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الإذعان، وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دون: فالكفر أعظم من الفسق، والفسق أعظم من العصيان، فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية، وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - في باب أحكام المرتد، وأما الفسق فهو دون الكفر، لكنه فعل كبيرة، مثل أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، والقذف، وما أشبه ذلك، والعصيان: هو الصغائر التي تكفَّر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: « الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفِّرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » () .
{ أولئك هم الراشدون }. أولئك: المشار إليه من حبب الله إليهم الإيمان وزيَّنه في قلوبهم، وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان {هم الراشدون } يعني الذين سلكوا طريق الرشد، والرشد في الأصل: حسن التصرف، وهو في كل موضع بحسبه، فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه، ولا يبذله في غير فائدة، والرشد في الدين: هو الاستقامة على دين الله - عز وجل - فهؤلاء الذين حبَّب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون، وهنا تجد هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله، ولهذا قال بعدها: {فضلاً من الله } يعني أن الله أفضل عليكم فضلاً أي تفضُّلاً منه، وليس بكسبكم، ولكنه من الله - عز وجل - ولكي يُعلم أنّ الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص، فمن علم الله منه حُسن النية، وحُسن القصد والإخلاص حبَّب إليه الإيمان وزيَّنه في قلبه، وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، ومن لم يعلم الله منه ذلك فإنَّ الله تعالى يقول: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم } ويقول الله - عز وجل -: {فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم } فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان، فهؤلاء الذين تفضَّل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وُفقوا للحق، قال الله - عز وجل -: {فضلاً من الله ونعمةً } يعني إنعاماً منه عليهم، والنعمة نعمتان: نعمة في الدنيا، ونعمة في الآخرة، فنعمة الدنيا متصلة بنعمة الآخرة في حقهم. وأما الكفار فهم منعَّمون في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: {كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين } أي تنعُّم، فهؤلاء الكفار عليهم نعمة في الدنيا، لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله، أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعاً، على نعمة في الدنيا، ونعمة في الآخرة، حتى وإن كان فقيراً أو مريضاً أو عقيماً، أو لا نسب له، فإنه في نعمة، لقول الله تعالى: {من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبةً ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون } .
وخلاصة الكلام في النعمة، أن هناك نعمتين: نعمة عامة لجميع الخلق، الكافر والمؤمن، والفاسق والمطيع، ونعمة خاصة للمؤمن، وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا، وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة {والله عليم حكيم } هذان إسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائماً: العلم والحكمة، عليم بكل شيء، قال الله تعالى: {لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما }. وقال تعالى: {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأَرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأى أرض تموت }. وقال تعالى: {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمهآ إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأَرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين }. وقال تعالى: {إن الله لا يخفى عليه شيء في الأَرض ولا في السماء }. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والإنسان إذا علم أن الله محيطبكل شيء حتى ما يضمره في قلبه، فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه - عز وجل - ولا يقول قولاً يغضب الله، ولا يفعل فعلاً يغضب الله، ولا يضمر عقيدة تُغضب الله؛ لأنه يعلم أن الله - سبحانه وتعالى - يعلم ذلك، لا يخفى عليه، وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق ومطابق للمصالح، ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة، قال الله تبارك وتعالى: { حكمة بالغة فما تغنى النذر }. وقال تعالى: {أليس الله بأحكم الحاكمين }. وقال تعالى: {ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون }. فمعنى الحكيم، أي ذو الحكمة البالغة، وله معنى آخر وهو: ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم، كما قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله }. وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأَخر } ولا أحد يحكم بهواه {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأَرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون }
شكرا لكم .
